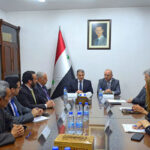من الأشياء التي أقوم بها ولا يعلن عنها، أنني أترجم لمعهد جوتة بروفات الكتب التي ستترجم إلى العربية. والبروفة هنا تعني المقدمة والفصل الأول من كل كتاب يرسلونه إليّ سواء عمل فكري أو عمل أدبي. والحقيقة ترجمت إلى الآن ما يملأ مجلداً ضخماً ربما أنشره باسمي يوماً ما. المهم آخر كتاب أعجبني جداً وهو كتاب لمؤلف ألماني – يوناني اسمه (مارك تاركسيدس)، ويمكن أن ننقح عنوانه ليكون “الذاكرة لمن؟”. وهو يدور عن الصراع بين تصوراتنا المتناقضة حول الماضي الاستعماري والعنصرية، وكيفية كتابة التاريخ، وأي ذاكرة يُعتد بها في ذلك؟ أمس واليوم؟ هل هي ذاكرة المستعمِر أم المستعمَر؟
وفي الفصل الأول من الكتاب فقرة بعنوان “عصر الاكتشافات: العنف والمنولوج” تبدأ بمشهد لم أكن أعرف تفاصيله بهذه الدقة: ماذا حدث بالضبط عندما نزل كرستوفر كولومبس ومن معه على أول جزيرة دخلوها في العالم الجديد؟ وتأتي دقة المشهد وتأثيره من أن المؤلف اعتمد في بنائه على ما وصلنا من يوميات كولومبوس نفسه. ورغم أنني ترجمت هذا الفصل منذ ثلاثة أسابيع إلا أنني لم أنسه حتى الآن. وهو باختصار يقدمه كمقياس لكيفية كتابة التاريخ من الجانب الأوروبي، وكيف تعمل العنصرية حتى وأصحابها قلة في أرض غريبة.
لا شك أن الرحلة التي استمرت لشهرين ونصف الشهر كانت مرهقة، حيث انطلقت السفن الثلاث من ميناء “ولبة” الأندلسي إلى جزيرة “تَنرِيفي” في المحيط الأطلنطي الذي عبروه بأكمله في رحلة مليئة بالشك وعدم اليقين. ويصف كولومبوس بالتفصيل مشاكل العبور، واستياء رجال الطاقم، الذين اعتبروا -بسبب الخوف- كل حدث في الرحلة بمثابة نذير شؤم. حتى إنهم لم يشعروا بأية إثارة عند الإعلان عن أنه توجد أرض على مرمى البصر بسبب هذا التشاؤم، ربما لأنهم تشككوا في الأمر.
وكانت الجزيرة التي رأوها تسمى “جواناهاني” (Guanahani)، وهي الآن تعد جزءاً من جزر البهاما. وهنا يكتب كولومبوس في يومياته: “هناك رأينا على الفور سكاناً أصليين عراة”. وكان سكان الجزيرة المسالمين يتطلعون من مخابئهم إلى هؤلاء الأغراب البيض الذين نزلوا من سفنهم ودخلوا الجزيرة بقوارب مسلحة. فيما كانوا يفكرون؟ وهل كانوا يتوقعون ما ينتظرهم؟ هذا ما لا نعرفه بالضبط، ومما لم يهتم به كولومبوس أيضاً؛ فهو كما يقول المؤلف لم يهتم بالحوار مع هؤلاء السكان الأصليين، ولا حتى بالإشارة.
كان هدف كولومبوس هو “تأكيد الاستحواذ والاستيلاء” على تلك الجزيرة باسم التاج الإسباني. وكان كولومبوس قد اتفق مع التاج الإسباني على الحق في الاحتفاظ بـ10% من كل ما يتم العثور عليه، من التوابل والذهب والفضة والأحجار الكريمة، وكذلك من البضائع الأخرى التي يمكن الفوز بها.
وبعد أن دخل الجزيرة رفع العلم الإسباني الملكي ثم قام بدعوة رفاقه كي يجتمعوا معاً حتى يتمكنوا من الشهادة على إتمام “الاستيلاء” أي كي يكونوا شهوداً عليه.
وهنا بدأ سكان الجزيرة يجتمعون أيضاً لرؤية ما يفعله هؤلاء الأغراب. وبعد رفع العلم الملكي الإسباني بدأ مسؤول ملكي يقرأ وثيقة الاستيلاء، باللغة القشتالية بالطبع. وهي كما استنتجت أنت الآن لغة لا يعرفها سكان الجزيرة، وبالتأكيد لم يترجم شيء من الوثيقة لهم لأن الإسبان بالتأكيد لا يعرفون لغة سكان الجزيرة!
ومما جاء في وثيقة الاستيلاء أن هذه الأرض سيتم إدماجها بالمملكة الإسبانية، وأن الهدف من الإدماج أو الاستيلاء هو “إنقاذ” هؤلاء السكان الأصليين من خلال تحويلهم إلى “العقيدة الكاثوليكية المقدسة”. وهنا وجّه المسؤول الملكي كلامه إلى السكان الأصليين المجتمعين وطلب منهم “التفضل بالانتقال إلى الإيمان المسيحي الكاثوليكي”. وأخبرهم بأنهم في حالة الموافقة على ذلك يمكن أن يصبحوا رعايا أحراراً للتاج القشتالي، ولكن إذا رفضوا ولم يستجيبوا، فلا قيود عليهم كإسبان فيما يمكن أن يفعلوه بهم، وسيكون “القتل والضرر الناتج عن رفضكم هو ذنبكم أنتم ولا يتصل بأي سبب لسموه الملكي”.
وكتب كولومبوس في يومياته أنه أراد تحقيق خلاصهم هذا عن طريق الحب وليس عن طريق السيف. ومن هنا وزّع وجنوده على السكان الأصليين المجتمعين هدايا بسيطة؛ قبعات حمراء وعقوداً زجاجية حمراء وأشياء أخرى صغيرة، ذات قيمة قليلة. وقد فرح السكان الأصليون بتلك الإيماءة السلمية من هؤلاء الوافدين البيض. أما كولومبوس فكتب في يومياته أن هذا الفرح أظهر له جهلهم الطفولي مقابل تفوقه كأوروبي كاثوليكي.
ويحلل المؤلف المشهد الأولي كنموذج يمكن أن يقاس عليه للقاء الأوربي بالآخرين في الخارج، ويعتبره شاهداً على بداية نوع جديد من العنصرية. وهنا يستشهد برأي لعالِم الاجتماع المعروف إيمانويل والرشتاين يرى فيه أن العنصرية الحديثة أظهرت شبكة جديدة تماماً من العلاقات في العالم. والشيء المميز في هذه العنصرية أنها تستعبد الناس بإدماجهم في منظومة العنصرية. فمنظومة العنصرية هذه لا تعمل وتستمر إلا بوجود من تُمارس ضده. فالطرف الذي تقع عليه الممارسة العنصرية مدمج بشكل أو آخر في المنظومة العنصرية نفسها.
ويشرح كيف تعمل هذه العنصرية بأنه لا يجب إجراء حوار على الإطلاق. وأنه في الوقت الذي توزع فيه الهدايا والملاحون يحاولون مغازلة نساء الجزيرة شبه العاريات، يتم تحويل السكان كلهم، في أحسن الأحوال إلى رعايا للتاج القشتالي، وإن شئنا الدقة إلى رعايا غير ناضجين وذوي عقيدة خاطئة.
المشكلة هنا أن السكان الأصليين ليسوا “غرباء” يثيرون الفضول أو الخوف، فهم في موطنهم وبينما الإسباني الغازي هو الغريب هنا، ومع ذلك تصرف مباشرة مع السكان الأصليين كأنهم من ممتلكاته. وأنهم بصفتهم غير مسيحيين سيصبحون أهدافاً مستقبلية للإجراءات والتدابير الملكية والكنسية. وكما يقول المؤلف فإن الإسبان استغلوا بلا خجل حقيقة أن السكان الأصليين لم يكونوا مسيحيين. فنشروا المسيحية بينهم بالسيف واستغلوها كأساس لممارسة القمع والعنف.
وعندما فهم السكان الأصليون ما يراد لهم رفضوا أن يصبحوا ممتلكات للملك الكاثوليكي، وبدأوا في القتال. وهنا ظهرت أول الكليشيهات الاستعمارية الأوروبية، حيث بدأ الرهبان المنصرون يشنعون على السكان الأصليين من منظور مخالفتهم للمقاييس المسيحية الكاثوليكية. فهم كما قال أحد هؤلاء الرهبان يسيرون وهم عراة تماماً، ولا احترام لديهم للعذرية. وأنهم أغبياء متقلبون، ولا يؤمنون بالعناية الإلهية. هم مخربون عنيفون، ويجعلون أخطاءهم الفطرية المتأصلة أسوأ.
وبالطبع مثل هذه الكليشيهات، خاصة عن الأخلاق الفطرية المتأصلة، لها وظيفة استعمارية محددة، وهي تبرير الاستعمار وإظهاره كضرورة. وهذا ما يدعيه الغزاة دوماً كأنه لم يكن لديهم خيار آخر. فهم دوماً ما يجدون أو يخترعون أسباباً حول اضطرارهم لاستعمار الآخرين وقمعهم أو إفنائهم. وهذا ما حدث لسكان هذه الجزيرة المنكوبة، فلم يكد يمر ربع قرن حتى خلت من سكانها تماماً إما بقتلهم أو باستعبادهم وبيعهم في جزر أخرى بعيدة.
وفي الكتاب إحصائيات مفزعة منها أن عدد السكان الأصليين في الأمريكتين كان يقدر عند وصول الإسبان بحوالي 80 مليوناً من البشر، وبعد قرن واحد من السيطرة الإسبانية أصبح عدد هؤلاء السكان الأصليين أقل من 10 ملايين. وقد حدث هذا إما بسبب الحروب التي شنها الإسبان على هؤلاء السكان الأصليين أو بسبب الأمراض المكروبية التي نقلوها إلى هذا العالم الجديد.
ويرى المؤلف أن مثل هذا التبرير الاستعماري هو ظاهرة حديثة؛ ففي العصور القديمة لم يكن من الضروري إضفاء الشرعية على الغزو والاستعباد. فقط في العصر الحديث احتاج الأمر إلى تبرير.
ومنذ هذا العصر أصبح الغرب كما يقول المؤلف مكاناً موبوءاً بالازدواجية والتناقض. فمن ناحية يزداد التقدم والازدهار والحرية والديمقراطية، بينما من جهة أخرى يزداد القمع والاستغلال والإقصاء. ولذا يمكن فهم العنصرية على أنها “جهاز” تسير فيه ممارسة القمع جنباً إلى جنب مع تكوين المعرفة التي تفسر القمع وتضفي الشرعية عليه.
وهذا يبرر استمرار التصورات نفسها حتى اليوم حول “الأجانب” أو اللاجئين أو حول “المسلمين” على سبيل المثال.
مقالات الرأي المنشورة في عربي بوست لا تعبر عن عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع